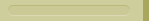عاشوراء البطولة والقيم
يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ [سورة النساء، الآية: 76].
البطولة هي الشجاعة الفائقة التي لا يتصف بها إلّا قليل من البشر، جاء في لسان العرب: البَطَل شُجَاع تَبْطُل جِرَاحته فَلَا يكتَرِثُ لَهَا وَلَا تَبْطُل نَجَادته، وَقِيلَ: إِنّما سُمّي بَطَلًا لأَن الأَشدّاءِ يَبْطُلُون عِنْدَهُ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي تَبْطُلُ عِنْدَهُ دِمَاءُ الأَقران فَلَا يُدْرَك عِنْدَهُ ثَأْر[1] .
وكان هذا المفهوم يستخدم في ساحة المعارك والحروب، فالمقاتل الشجاع الذي توفرت فيه قوة الجسم وقوة النفس، بحيث يتغلب على الآخرين ويوقع الهزيمة بهم، يُسمّى بطلًا.
ثم اتسع استخدام هذا المفهوم ليشمل سائر الميادين، فالمتفوق على الأقران، والمتقدّم على الأنداد، والذي يحقق إنجازات متميزة في أيّ ميدان من ميادين الحياة، يطلق عليه بطل. لذلك هناك أبطال في مجال العلم والمعرفة، والأدب والفنون، وفي مجال القيادة السياسية والاجتماعية، وفي المجال الرياضي، فيقال بطل الملاكمة، وبطل كرة القدم. فالبطل من يمتلك قدرات فائقة، على إنجاز ما لا يستطيع أيّ كان إنجازه. وقد يحقق الإنسان البطولة في أكثر من ميدان.
ونذكر هنا كتاب الأبطال للفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل (1795-1881م) حيث تحدّث عن البطل في صورة الإله، وفي صورة الرسول، وفي صورة الشاعر، وفي صورة القسيس، وفي صورة الكاتب، وفي صورة الملك.
البطل حاجة حضارية
ولا يقتصر دور الأبطال في المجتمعات الإنسانية على ما يحققونه من إنجازات في مسيرتهم البطولية، فهم إلى جانب ذلك يملؤون نفوس أبناء مجتمعاتهم بالفخر والثقة، ويلهمونهم إثبات الذات والتطلع إلى آفاق التقدّم، والتغلب على المشاقّ والصعوبات.
لذلك أصبح وجود الأبطال حاجة حضارية في المجتمعات الإنسانية، فلكلّ شعب ولكلّ أمة أبطالها، وقد تضفي شعوب ومجتمعات على بعض قادتها ورموزها في حياتهم أو بعد موتهم، صفات خارقة بشكل أسطوري، لتخلق منهم أبطالًا يملؤون فراغ البطولة في تاريخها وثقافتها. بل قد تختلق لها أبطالًا أسطوريين.
مما يعني الشعور بالحاجة إلى وجود الأبطال، لقيام نهضة الأمم والشعوب.
البطولة والقيم الأخلاقية
وإذا كانت مستويات البطولة مختلفة وميادينها متعددة، فإنّ هناك بعدًا أساسًا لا بُدّ من توفره لتستحق شخصية البطل الإكبار والتمجيد، وهو البعد القيمي الأخلاقي، فإنّ البطولة مع فقدان هذا البعد في شخصية الإنسان وسلوكه تفقد قيمتها الحقيقية ودورها الإيجابي في الحياة الاجتماعية.
فمن دون القيم والأخلاق، قد يوظّف البطل قدرته في مجال تفوقه للإضرار بالآخرين، والإفساد في الحياة.
وحينئذٍ لا يستحقّ التمجيد، ولا أن يكون قدوة للأجيال. بل يكون وبالًا على الناس والحياة، ومستحقًا للذمّ والازدراء.
فالبطل الشجاع إذا استخدم بطولته في العدوان والبطش بالآخرين، واستهداف الأبرياء، هل يستحقّ الاحترام والتقدير في المنظار الإنساني؟
والعالم المتفوق إذا وظّف علمه في خدمة الظلم والفساد، والإضرار بمصالح الناس والحياة، هل يكون جديرًا بالإكبار والتمجيد؟
قالوا بأنّ أبًا كان يعاني من سوء تصرفات ولده، ويعاتبه دائمًا بقوله: متى تكون آدميًا؟ متى تكون إنسانًا؟ ثم ضاق به ذرعًا وطرده من بيته، فخرج الولد إلى منطقة أخرى، ودخل في السلك العسكري، وتدرّج حتى أصبح قائدًا لشجاعته القتالية، وجاء يومًا بموكبه العسكري إلى مدينته السابقة، فخرج الناس في استقبال الموكب، وكان أبوه من جملة الناس، وهو لا يعرف أنّ هذا القائد هو ابنه، فلما لمح أباه، أنحى بفرسه نحوه، ثم خاطب أباه بتبجّح وهو على فرسه: ألا تعرفني؟ أنا ابنك الذي كنت تقول له: متى تكون آدميًا؟ متى تكون إنسانًا؟
ها أنا قد صرت قائدًا عسكريًا كما ترى!
فأجابه الوالد فورًا: نعم، لقد أصبحت قائدًا عسكريًا، ولكنك بعد لم تصبح آدميًا إنسانًا! قال: وكيف؟ قال له: لو كنت آدميًا إنسانًا لما خاطبت أباك بتبجح وأنت على ظهر فرسك!!
إنّ القيم والأخلاق لا تسمح للإنسان بأن يتعالى على والديه، أو يترفع عن خدمتهما والتواضع لهما، مهما كانت كفاءته وقدراته، ومهما كان ضعف مستوى والديه.
إنّ الله تعالى يقول: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [سورة الإسراء، الآية: 24].
تمجيد الأبطال القيميين
إنّ توجه الأوطان والمجتمعات لتنمية كفاءات أبنائها في مختلف المجالات، لصنع جيل من المتفوقين والمتميزين في المجالات العسكرية والأمنية والعلمية والاقتصادية، يجب أن يرافقه اهتمام بتربية الأبناء على القيم والالتزام الأخلاقي، ليكونوا قادة وأبطالًا أمناء على مصالح أوطانهم ومجتمعاتهم، وجديرين بالتقدير والاحترام.
ومن المناهج المؤثرة في التربية على القيم والأخلاق، ترسيخ صور الأبطال القيميين، في ذاكرة ونفوس أبناء المجتمع، ليكونوا مصدر إلهام، وموضع تأسٍّ واقتداء.
لهذا خلّد القرآن الكريم أسماء الأنبياء والقادة الصالحين، وسجّل مواقفهم القيمية المبدئية، وأمر بذكرهم وإحياء سيرتهم، نبراس هداية للأجيال.
يقول تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ [سورة مريم، الآية: 16].
ويقول تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾ [سورة مريم، الآية: 41].
ويقول تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ [سورة مريم، الآية: 54].
وآيات كثيرة في هذا السياق.
من هنا تأتي أهمية موسم عاشوراء في مجتمعاتنا، حيث نحتفي فيه بالبطولة الممتزجة بالقيم والمبادئ، من خلال الملاحم البطولية التي سطّرها سيد الشهداء الحسين بن علي  وأصحابه الأوفياء الأبطال، والمواقف القيمية الأخلاقية النبيلة التي جسّدوها في مواجهة معسكر الضلال والانحراف.
وأصحابه الأوفياء الأبطال، والمواقف القيمية الأخلاقية النبيلة التي جسّدوها في مواجهة معسكر الضلال والانحراف.
إنهم كانوا يقاتلون في سبيل الله من أجل قيم الحقّ والعدالة وحرية الإنسان، بينما كان المعسكر الأموي يقاتل في سبيل الطاغوت، من أجل المصالح والمكاسب المادية الزائلة.
أبطال كربلاء
لقد تحدّث رواة التاريخ عن مستوى البطولة الفائقة، التي تحلّى بها أبطال كربلاء، فكانوا عددًا قليلًا لا يتجاوز الثمانين شخصًا على أعلى التقديرات[2] ، يواجهون جيشًا مدججًا بالسلاح يصل عدده إلى حوالي 30 ألفًا، وأقلّ رقم ذُكر هو أربعة آلاف مقاتل[3] .
جاء في تاريخ الطبري في وصف قتال أنصار الحسين يوم عاشوراء: وقاتلوهم حتى انتصف النهار أشدّ قتال خلقه الله[4] .
وقيل لرجل شهد الطف مع ابن سعد: ويحك! أقتلتم ذرية الرسول؟!
فقال: عضضت بالجندل، إنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا، ثارت علينا عصابةٌ أيديها على مقابض سيوفها كالأسود الضارية، تحطّم الفرسان يمينًا وشمالًا، تلقي نفسها على الموت، لا تقبل الأمان، ولا ترغب في المال، ولا يحول حائلٌ بينها وبين المنية أو الاستيلاء على الملك، فلو كففنا عنها رويدًا لأتت على نفوس العسكر[5] .
وقال عمرو بن الحجاج الزبيدي أحد قادة الجيش الأموي، ناهيًا عن المبارزة الفردية لأنصار الحسين، مخاطبًا جنود الجيش الأموي: يا حمقى، أتدرون من تقاتلون؟ فرسان المصر قومًا مستميتين لا يبرزن لهم منكم أحد[6] .
ويقول المؤرخ الإنجليزي (سر پرسي سايكس: إنّ الإمام الحسين وعصبته المؤمنة القليلة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلّت تتحدّى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون وحتى يومنا هذا)[7] .
إلى جانب هذه البطولة المتميزة والشجاعة الفائقة، كانوا قمة في التزامهم القيمي والأخلاقي، حتى وصفهم الإمام الحسين  بقوله: إِنّي لا أعلَمُ لي أصحابًا أوفى ولا خَيرًا مِن أصحابي[8] .
بقوله: إِنّي لا أعلَمُ لي أصحابًا أوفى ولا خَيرًا مِن أصحابي[8] .
وقد سجّل التاريخ كثيرًا من مشاهد وصور الحالة القيمية والأخلاقية في سيرة هؤلاء الأبطال الحسنيين، فقد باتوا ليلة العاشر من المحرم، ولهم دويٌّ كدويِّ النحل، ما بين راكع وساجد، وقائم وقاعد، يصلّون ويستغفرون، ويدعون ويتضرعون[9] .
وفي وسط المعركة التفت أبو ثمامة الصائدي، وهو من فرسان العرب، إلى زوال الشمس، فخاطب الحسين فورًا: يا أبا عَبدِاللَّهِ، نَفسي لَكَ الفِداءُ! إنّي أرى هؤُلاءِ قَدِ اقتَرَبوا مِنكَ، ولا وَاللَّهِ، لا تُقتَلُ حَتّى أُقتَلَ دونَكَ إن شاءَ اللَّهُ، واُحِبُّ أن ألقى رَبّي وقَد صَلَّيتُ هذِهِ الصَّلاةَ الَّتي دَنا وَقتُها. قالَ: فَرَفَعَ الحُسَينُ عليه السلام رَأسَهُ، ثُمَّ قالَ  : ذَكَرتَ الصَّلاةَ، جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ المُصَلّينَ الذّاكِرينَ! نَعَم، هذا أوَّلُ وَقتِها، ثُمَّ قالَ
: ذَكَرتَ الصَّلاةَ، جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ المُصَلّينَ الذّاكِرينَ! نَعَم، هذا أوَّلُ وَقتِها، ثُمَّ قالَ  : سَلوهُم أن يَكُفُّوا عَنّا حَتّى نُصَلِّيَ[10] .
: سَلوهُم أن يَكُفُّوا عَنّا حَتّى نُصَلِّيَ[10] .
ورد عن أبي حمزة الثمالي: قالَ عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ  : كُنتُ مَعَ أبِيَ اللَّيلَةَ الَّتي قُتِلَ صَبيحَتَها، فَقالَ لِأَصحابِهِ: هذَا اللَّيلُ فَاتَّخِذوهُ جَمَلًا؛ فَإِنَّ القَومَ إنَّما يُريدونَني، ولَو قَتَلوني لَم يَلتَفِتوا إلَيكُم، وأنتُم في حِلٍّ وسَعَةٍ، فَقالوا: لا وَاللَّهِ، لا يَكونُ هذا أبَدًا. قالَ: إنَّكُم تُقتَلونَ غَدًا كَذلِكَ، لا يُفلِتُ مِنكُم رَجُلٌ. قالوا: الحَمدُ للَّهِ الَّذي شَرَّفَنا بِالقَتلِ مَعَكَ[11] .
: كُنتُ مَعَ أبِيَ اللَّيلَةَ الَّتي قُتِلَ صَبيحَتَها، فَقالَ لِأَصحابِهِ: هذَا اللَّيلُ فَاتَّخِذوهُ جَمَلًا؛ فَإِنَّ القَومَ إنَّما يُريدونَني، ولَو قَتَلوني لَم يَلتَفِتوا إلَيكُم، وأنتُم في حِلٍّ وسَعَةٍ، فَقالوا: لا وَاللَّهِ، لا يَكونُ هذا أبَدًا. قالَ: إنَّكُم تُقتَلونَ غَدًا كَذلِكَ، لا يُفلِتُ مِنكُم رَجُلٌ. قالوا: الحَمدُ للَّهِ الَّذي شَرَّفَنا بِالقَتلِ مَعَكَ[11] .
وقال سعيد بن عبد اللَّه الحنفي مخاطبًا الإمام  : وَاللَّهِ، لَو عَلِمتُ أنّي أُقتَلُ، ثُمَّ أُحيا، ثُمَّ أُحرَقُ حَيًّا، ثُمَّ أُذَرُّ، يُفعَلُ ذلِكَ بي سَبعينَ مَرَّةً ما فارَقتُكَ حَتّى ألقى حِمامي دونَكَ، فَكَيفَ لا أفعَلُ ذلِكَ! وإنَّما هِيَ قَتلَةٌ واحِدَةٌ، ثُمَّ هِيَ الكَرامَةُ الَّتي لَا انقِضاءَ لَها أبَدًا[12] .
: وَاللَّهِ، لَو عَلِمتُ أنّي أُقتَلُ، ثُمَّ أُحيا، ثُمَّ أُحرَقُ حَيًّا، ثُمَّ أُذَرُّ، يُفعَلُ ذلِكَ بي سَبعينَ مَرَّةً ما فارَقتُكَ حَتّى ألقى حِمامي دونَكَ، فَكَيفَ لا أفعَلُ ذلِكَ! وإنَّما هِيَ قَتلَةٌ واحِدَةٌ، ثُمَّ هِيَ الكَرامَةُ الَّتي لَا انقِضاءَ لَها أبَدًا[12] .
وذكر المؤرخون أنّ القاسم بن الإمام الحسن وكان فتى صغير السِّن، وصفوه بأنه كان جميلًا كأنّ وجهه شقة القمر، وفي أعلى تقدير أنّ عمره ست عشرة سنة، لذلك لم يأذن له الحسين حينما استأذنه للبروز للمعركة، فقبّل يدي الإمام ورجليه، وأصرّ كثيرًا عليه حتى أذن له.